تناول الباحث ما تنبئ عنه اللغة من خلال النظر في العلاقات القائمة بين ألفاظها ومدلولاتها حول كونها توقيفًا أو اصطلاحًا، وموقع اللغة بين اللغات السامية بل وبين سائر لغات الأمم، وتعبير اللغة عن العلاقة بين الإنسان والكون. وقد بحث الألفاظ المعبرة عن الجهات الأربع، ورأى أن الألفاظ التي يُعبَّر بها عن جهتي المشرق والمغرب المعلم عليهما بالشمس تعكس دلالتين تقعان على حدثين يمثلان الحياة والموت، ونقصد به الشروق والغروب، ويعلم على موضع شروق الشمس بجهة الشرق، وموضع غروب الشمس بجهة الغرب، وكل مادة تبدأ بشين فراء فهي تنصرف لدلالة تقع على معنى الخروج والظهور، وكل مادة تبدأ بغين فراء فهي لدلالة تنصرف لمعنى الاحتجاب والاختفاء، ولما كان اعتماد الإنسان قديمًا على حسه أكثر من عقله، وكان الشروق والغروب يُدركان بحاسة البصر، ولما كانت هذه الحاسة أشد الحواس توجيهًا للإنسان وتأثيرًا في معارفه وعلومه، فقد أدى ذلك إلى ظهور تلك الألفاظ في اللغة منذ أمد بعيد قبل الألفاظ المعبرة عن الشمال والجنوب. وكان العرب يعبرون عن جهتي الشمال والجنوب دائمًا وغيرهما أحيانًا بالظروف المبهمة مضافة إلى علم ما، كأن يقولوا: دون كذا، أو قبل كذا، وتلقاء كذا، وشطر كذا، وعن يمين أو شمال كذا أو شماله؛ فيُقال: تلقاء مدين، وشطر المسجد الحرام مثلاً. وكانت كلمتا الشمال والجنوب معروفتين للعرب قديمًا ولكن بدلالتين مختلفتين. ثم تناول الكاتب ما جرى عليه العرب من التعبير عن الجهتين اللتين يعبر عنهما بطلوع الشمس وغروبها باستخدام ألفاظ مثل: شرقيًا، الغربيّ، المشرق والمغرب، المشرقين والمغربين، المشارق والمغارب. أما كلمتا الشمال والجنوب بمدلوليهما المعروفين فعرفا بعد القرن الثاني الهجري بعدما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، واستقر العرب فيها، فجرى التحول إلى استخدام الشمال والجنوب لدلالتين تجاوران دلالتيهما على الريحين اللتين تهبان من قبل الشام واليمن؛ فأصبحتا تستوعبان الجهتين إلى جانب الريحين المذكورتين، وذلك لعلاقة الظرفية، حيث إن الجهتين هما مهباهما. وقد قرن العرب بين ريح الشمال وما يُتشاءم به، وبين ريح الجنوب وما يُتفاءل به، وفسّر الكاتب أسباب هذا الاقتران، ثم ناقش العلاقة بين الريح وروح الإنسان، وكيف أن الإنسان نفس والريح نفس، والإنسان نسمة والريح اللطيفة نسيم أو نسمة، وكيف ترتبط دلالاتها جميعًا بالحركة، ثم تحدث عن الدلالات والارتباطات الأخرى لكلمتي الشمال والجنوب.
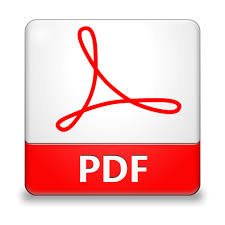
|