خيّم الغموض ردحاً من الزمن على تاريخ مكة رغم مكانتها السامقة في النفوس، بعد تراجع واضح من المؤرخين - سواء كانوا من أبنائها أو غيرهم - عن الكتابة فيه؛ فلا نرى من يُعنى بتتبع مناشط الحياة العامة في مكة ويُدوّن تاريخها بدقة وتوسع بعد وفاة مؤرخيها البارزين، مثل: أبي الوليد الأزرقي (ت حوالي سنة 250هـ/ 863م)، وأبي إسحاق الفاكهي (ت بعد سنة 272هـ/ 885م)، حتى قيّض الله تعالى لها تقي الدين الفاسي (ت 832هـ/ 1429م)، ونجم الدين بن فهد (ت 885هـ/ 1480م)، وابنه عز الدين (ت 922هـ/ 1516م)، وحفيده جار الله (ت 954هـ/ 1547م)، وغيرهم ممن شمروا عن ساعد الجد محاولين أن يتداركوا ما أهمل من التاريخ المكي، ويلموا شعثه بما صنفوه من كتب، حاولت - رغم عدم توافر المادة العلمية الكافية للفترة التي أعقبت الأزرقي والفاكهي - أن تغطي بمضامينها المختلفة جوانب هذا التاريخ المتعددة. وجاءت بعض كتب الرحلات لتتيح - بما جاء فيها من مادة علمية متنوعة - رافداً يسَّر للباحثين الوصول لبعض الحقائق التاريخية والمعلومات الحضارية المهمة، وكانت خير معين في رفع الستار، وكشف الغموض عن أجزاء مبهمة أو غير واضحة من تاريخ مكة في فترته الغامضة. ويأتي كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" الذي صنفه محمد بن أحمد المقدسي - بعد رحلة أمضاها سائحاً في الأمصار الإسلامية إبان النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، ومتردداً خلال ذلك على مكة حاجاً ومجاوراً - من أبرز الكتب التي صنفت في هذا المجال بعد أن حرص المقدسي على أن يُخرج هذا الكتاب وفق خطة مرسومة تخضع لمعايير منهجية واضحة وصارمة. ولا غرو فقد أرضى المقدسي طموحه وتطلعاته حتى أصبح مصنفه، بمنهجه المتميز، ومادته العلمية الثرة والمتنوعة التي بزّ بها سابقيه ومعاصريه من الجغرافيين والرحالة، مرجعاً للكثير من الباحثين، ومثار إعجاب عدد من الكتاب المحدثين، سواء كانوا من العرب أو المستشرقين، ممن أفاضوا في دراسة منهجه، والإفصاح عن مكانته وقيمته العلمية(1).
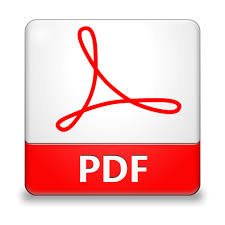
|